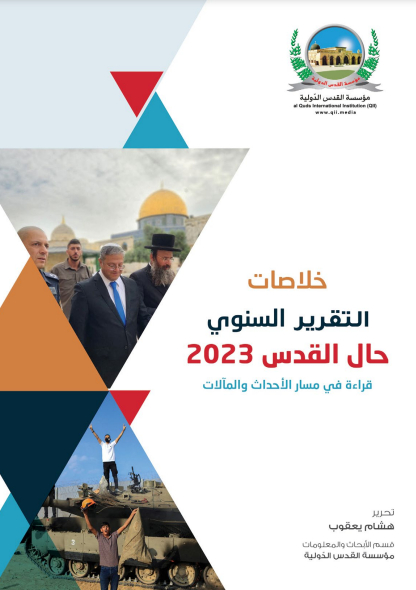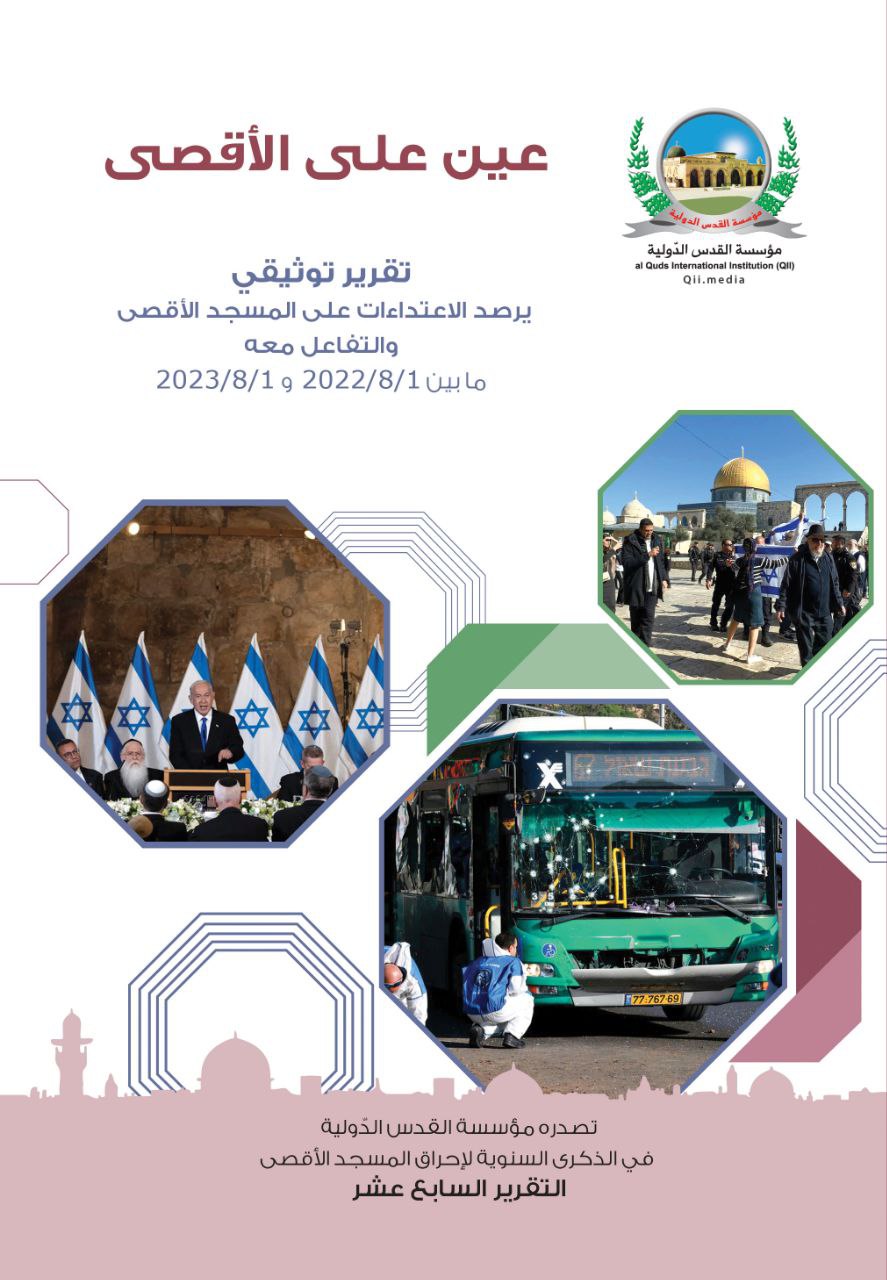القدس العثمانية نمو خارج الأسوار روشيل ديفيس
القدس العثمانية نمو خارج الأسوار روشيل ديفيس
مقدمة
إن النظرة التقليدية إلى القدس إبان احتلال بريطانيا لها سنة 1917، تصورها مدينة راكدة ومتخلفة سواء كمركز اقتصادي أو من ناحية مستوى المعيشة ويعزى دور أساسي في تكوين هذه النظرة إلى المخطوطات التي وضعها موظفون إداريون بريطانيون ورحالة مسيحيون أوربيون إلى الأرض المقدسة كانوا قد أسقطوا على نظرتهم إلى فلسطين قيمهم الخاصة ومستويات معيشتهم كأفراد من الشريحة العليا في الطبقة الوسطى وبرامجهم السياسية الدينية في حقبة الاستعمار ومساعيهم الخيرة وعلم تحسين السلالات كما ساهمت بالمقدار نفسه في تكوين هذه النظرة مؤلفات كثير من الباحثين الصهيونيين الحاليين والسابقين على حد سواء الذين غالباً ما اختاروا أن يركزوا على تخلف القدس بطريقة مبرمجة لا لإبراز طبيعة المدينة الفريدة وتطوريها وإنما لتأكيد ما جلبه المشروع الصهيوني إليها وهذا لا ينفي أن قيمة القدس تكمن أساساَ في أهميتها الدينية أكثر مما هي إنتاجيتها التجارية والزراعية لكن تصوير المدينة وكأنها اكتسبت أهميتها وجدارتها بفضل الجهود الصهيونية وإدارة الانتداب البريطانية يحدّ بلا مبرر من إمكان إثراء النقاش في شأن فلسطين العثمانية عامة والقدس خاصة كما أنه يتجاهل خلفية التغيرات التي حدثت في المدينة في النصف الأول من القرن العشرين.
هناك إيضاحات لا بد منها تتعلق ببعض المصطلحات المستخدمة في هذا الفصل فالمدينة الجديدة تشير إلى الأجزاء من القدس التي بنيت خارج المدينة المسورة البلدة القديمة وستستخدم المصطلحات يهودي ومسيحي ومسلم دائماَ لا لأن هذه المصطلحات الدينية ملائمة بالضرورة للإشارة إلى الفئات والطوائف لكن لأن الإحصائيات العثمانية والبريطانية قائمة على هذا الأساس كما أن استخدام مصطلحي عربي ويهودي يتبع ما هو دارج في الكتابة عن موضوع مع أن هذين المصطلحين يستثنيان قطاعاَ مهماًَ من المقدسين الأرمن واليونان والحبش وغيرهم الذين ربما عاشوا في المدينة جيلاَ بعد جيل ويعتبرون أنفسهم مقدسين بالتأكيد إن قسماَ كبيراَ من هؤلاء يعتبرون أنفسهم فلسطينيين ومع أنه يمكن استخدام مصطلح فلسطيني لوصف السكان العرب والجماعات الأخرى غير اليهودية بناء على الميول السياسية والانتماءات الوطنية فإن هذا المصطلح يشمل أيضاَ مواطني فلسطين من اليهود حتى سنة 1948، وبما أن القدس كانت جزءاَ من ساحة أوسع للصراع بشأن الأرض بين العرب اليهود فإن مصطلحي عرب ويهود سيستخدمان دوماَ مع الإشارة إلى أن المقصود بالعرب هو الفلسطينيون العرب أكانوا مسلمين أم مسيحيين والجماعات الإثنية الأخرى التي أجليت عن الدولة اليهودية عندما أقيمت في سنة 1948.
يتناول هذا الفصل نمو القدس خارج أسوار البلدة القديمة الذي بدأ في منتصف القرن التاسع عشر وعند اقترب القرن من نهايته فإن الأوضاع السكينة المزدحمة في البلدة القديمة والنمو الاقتصادي والسكاني في فلسطين وتحسن الوضع الأمني بفضل ازدياد الوجود الإداري والعسكري العثماني أدت كلها إلى جعل فكرة الإقامة خارج الأسوار خياراََ مقبولاَ وممكنا لدى عدد متزايد والدور النشيط الذي قامت به الكنائس الأجنبية والمحلية والذي أتاح لكثير من الفلسطينيين المسيحيين بناء منازل أو استئجار عقارات تابعة للكنائس في الأحياء الغربية إنني آمل بأن أستثير نظرة أكثر تدقيقاَ في المصادر المتعددة وأن أضع موضع التساؤل بعض التوجهات في الدراسات التي تعالج موضوع نمو القدس من خلال نظرة نقدية إلى النماذج المطروحة في النقاشات الصهيونية والإسرائيلية لنمو المدينة الجديدة.
القدس العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر مدينة متغيرة
كان تعداد سكان المدينة في السبعينيات من القرن التاسع عشر ما بين 14ألف و22ألف نسمة وكما هو موثق جيداَ في مصادر أخرى كانت المدينة مركزاَ للحياة الدينية للمسلمين والمسحيين واليهود وخلال القرن التاسع عشر ازداد في الأرض المقدسة النشاط الديني القادم من أوربا وقد تضافرت التوجهات السياسية للقوى الأوربية نحو تغلغل حضاري ديني مع الإصلاحات العثمانية المتعلقة بالأراضي في سنتي 1839- 1856 التي سمحت للمواطنين من غير العثمانيين بتملك الأراضي وجعلت القدس والأراضي المقدسة بأسرها كما يذكر شولش حلبة صراع للمناقشات الأوربية هذا النشاط الديني بتضافره مع الإصلاحات العثمانية في جميع أنحاء الإمبراطورية حوّل القدس في نهاية الحكم العثماني إلى مدينة مختلفة جداَ عما كانت عليه قبل قرن من نواحي السكان والامتداد والمباني والبنية التحتية
مع نهاية الحكم العثماني للقدس في سنة 1917م، كان تقدم تكنولوجي أساسي قد أحدث تغيرات في الحياة في المدينة من عدة نواح ففي سنة 1892م، أنشئ خط سكة حديد ربط بين القدس وميناء يافا الأقرب إليها واستخدام هذا الخط في الأعوام الأولى بصورة واسعة لنقل الحجاج المسافرين لكن سرعان ما استغل لنقل البضائع كما ربطت طرقات واسعة ملائمة للعربات بين القدس من جهة ويافا ورام الله ونابلس والخليل عبر بيت لحم وأريحا من جهة أخرى بالإضافة إلى قرية عين كارم المجاورة ومقام النبي صموئيل ومع بداية القرن كانت أرصفة من الحصى قد أنشئت على جانب الطرق الداخلية في مدينة القدس الجديدة طريق نابلس وطريق ماميلا وحي محانيه يسرائيل وطريق يافا وشارع الأنبياء ومنذ سبعينيات القرن التاسع عشر وصلت خطوط التلغراف مدينة القدس بمصر وبيروت وأوربا وتمتع السكان بخدمات بريدية متعددة عثمانية وروسية وألمانية ونمساوية وفرنسية وإيطالية لكنها لم تكن موحدة وذكرت بيرتا سبافورد وهي أمريكية كانت تقيم في القدس أن السلطات التركية سمحت لهم بتركيب هاتف في الكولونية الأمريكية واقتبست عن كاتب هو الجوال المتدين قوله وصلت الرسمية ومن ثم سيجري تزويد المكاتب والمنازل بأجهزة الهاتف.
في سنة 1892، صدر فرمان خاص بتأليف مجلس بلدي وكان من جملة أعماله إنشاء نظام صرف صحي في سبعينات القرن التاسع عشر وفي التسعينات جرى تنظيم جمع القمامة بصورة دورية وعلقت مصابيح الكاز لإضاءة المدينة وكانت الشوارع ترش بالماء في أوقات معينة من السنة لمنع تطاير الغبار وفي سنة 1892، افتتحت حديقة عامة للجمهور في المدينة الجديدة في شارع يافا قبالة المسكوبية حيث كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف فيها يومي الجمعة والأحد وقبل الحرب العالمية الأولى بفترة وجيزة زرعت أشجار على امتداد بعض الشوارع ونوقشت خطط لإدخال الحافلات الكهربائية ونظام الهاتف إلى المدينة وفي سنة 1914، منحت بلدية القدس امتيازاً من أجل تزويد المدينة بالكهرباء وشملت التغيرات الأخرى التي أحدثتها البلدية إنشاء قوة شرطة للمدينة في سنة 1891 افتتح مشفى مجهز بـ 32سريراَ ومفتوح للعامة مع معالجة مرضى القرى المجاورة مجاناَ ثلاث مرات في الأسبوع وبحسب شالش فإن البلدية بدأت بمنح تراخيص بناء حفظ سجل لها منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعداَ وفي سنة 1907، صدر قانون يقضي بالحصول على تراخيص من أجل البناء أو توسيع المنازل أو إضافة طبقات أخرى
استخدمت المطابع أول مرة في المدينة في الأربعينيات من القرن التاسع عشر وكانت توجد في تلك الفترة مطابع في دير اللاتين الفرنسيسكان ودير الأرمن ولدى طائفة الروم الأرثوذكس والطائفة اليهودية وكانت منشوراتها الأولى محصورة في النصوص الدينية والتفاسير ثم وسع أصحابها عملهم لاحقاً وبين سنتي 1876-1916، صدر عدد من الجرائد والدوريات العربية منها الجريدة الحكومية القدس الشريف وجريدة باكورات جبل صهيون وهي مطبوعة أصدرها أسايذة وطلاب مدرسة المطران غوبات وفي سنة 1908 صدرت في القدس اثنتا عشرة مطبوعة جديدة كما صدرت في تلك الفترة الصحيفتان المشهورتان فلسطين من يافا والكرمل من حيفا
وقام بدور مهم في الحياة الفكرية للمدينة عدد من المربين الذين كرسوا حياتهم لعلمهم ومثلهم العليا ومن أكثرهم احتراماَ نخلة زريق المعروف في التاريخ الفلسطيني بتأثيره الكبير في منهجية التعلم وتعليم اللغة العربية وقد ولد في بيروت سنة 1861، وجاء إلى القدس سنة 1889، ليدرس فيها بناء على طلب إرساليات تبشيرية إنكليزية وبالإضافة إلى دوره الفاعل في إحياء اللغة العربية كان عضواَ في حلقة أدبية ضمت أدباء القدس مثل سليم الحسيني رئيس بلدية القدس سابقاً وموسى عقل وفيضي العلمي وفي سنة 1898، أسس عدد من مثقفي القدس بينهم زريق جمعية الأدب الزاهرة وكان رئيسها داود الصيداوي وضمت بين أعضائها عيسى العيسى وفرج فرج الله وافتيم مشبك وشبلي الجمل وجميل الخالدي وخليل السكاكيني.
التعليم في القدس العثمانية
شهد القرن التاسع عشر توسعاًَ هائلا في فرص التعليم لأبناء النخبة بمن فيهم الفتيات وبينما حدث إصلاح عثماني بسيط في التعلم بهدف توفير كوادر عسكرية ومدنية للخدمة في الدولة فإن مشاريع الإرساليات الأجنبية أسست أنواعاً متعددة من المدارس وفي جميع أنحاء المشرق أدت هذه المدارس دوراَ رئيسياَ في تعليم المسحيين تحديداَ إذ لم تسمح السلطات العثمانية للطلاب المسلمين بالالتحاق بها إلا في أواخر القرن وأحدث تعرض المقدسين لأنظمة التعليم واللغات ووجهات النظر الأوربية تأثيراَ ملموساً في حياتهم من الناحيتين الاجتماعية والسياسية وبدا هذا الأثر جلياً وبأشكال متعددة منها نمط اللباس والتذوق الموسيقى والأدب وحقول الدراسة وغيرها كما نجح في أن يغرس في الطلاب مسحيين ومسلمين على حد سواء وعيا متنامياَ بهوية ثقافية عربية وبالإضافة إلى ذلك كان للمدارس التبشيرية أهداف تربوية ثقافية متنوعة وتوجهات سياسية اجتماعية نجم عنها توفير فرص تعليمية للفقراء والفتيات تخطت الدراسة في الكتاتيب.
ويتضح من مطبوعة عن التعليم في سورية الكبرى ترجع إلى سنة 1882، أن مدارس القدس كانت تضم ما مجموعة 3854طالباَ (2768فتي و 1086فتاة) و 235مدرساَ وكان عدد البنات في المدارس المسيحية (الإنجيلية والروم الأرثوذكس واللاتينية والروم الكاثوليك والأرمنية) أكثر قليلا من عدد الصبيان (926فتاة في مقابل 861صبياَ) ومع أن أغلبية هؤلاء الطلاب كانت مسيحية فإن أربعاً من المدارس الإنجيلية (مدرستين للصبيان ومدرستين للبنات) اقتصرت على تعليم اليهود بعدد إجمالي بلغ 138طالباَ وطالبة وبالإضافة إلى ذلك كان هناك 1707طلاب في مدارس يهودية 160 منهم فتيات أما في المدارس الإسلامية الثماني المخصصة جميعها للصبيان فقد كان هناك 360طالباَ وفي سنة 1891، افتتحت الحكومة مدرسة عامة ثانوية الرشدية كذا في مدينتنا حيث كان في إمكان أولاد المدينة كلهم بغض النظر عن ديانتهم أن يتلقوا دروساَ في اللغات العربية والتركية والفرنسية وفي العلوم الأساسية كما ورد ذكر تاسيس مدرسة إسلامية للبنات.
بنات صبيان المجموع مدارس إسلامية 0 360 360 مدارس مسيحية 926 861 1787 مدارس مسيحية للطلاب اليهود غير متوفر غير متوفر 138 مدارس يهودية 160 1547 1707 مجموع الطلاب 1086 2768 3854
كان أمام الطلاب الذين يودون متابعة دراستهم عدة خيارات بما فيها كليات تدريب المعلمين في القدس وجوارها وسافر آخرون ذكوراَ وإناثاَ إلى الخارج لإكمال دراستهم على الأغلب في كليات لبنان ومصر و إستنبول ووفرت جامعة الأزهر في القاهرة تعليماً إسلامياً لكثير من الطلاب الذين تخرجوا منها وعادوا ليصبحوا أئمة أو علماء شريعة في القدس وفي مختلف أنحاء فلسطين والتحقت ملكة ومارغريت غازمريان بكلية التمريض في بيروت وعملتا لاحقا في خدمة الحكومة العثمانية في سورية وكذلك فعل عزت طنوس الذي درس في كلية الطب في بيروت وقد وفرت هذه المعاهد مناخاً ثقافياً مملوءاَ بالإثارة وأتاحت المزيد من النقاش للقضايا المطروحة وقتئذ مثل القومية العربية والعلمانية والدارونية والإصلاح الإسلامي والمسحيين العرب وصلتهم بالكنائس الأجنبية وعاد الطلاب إلى بلادهم وهم ضليعون بهذه الأفكار والنقاشات
كانت الفرص التعليمية والثقافية التي وفرها ازدياد عدد المدارس كثيرة وبعيدة التأثير
أولاَ أدت إلى زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص المتعلمين في القدس وفي أجزاء أخرى من المشرق
ثانياَ تعلم كثير من الطلاب لغات أخرى بالإضافة إلى العربية والتركية اليونانية والروسية والفرنسية والإنكليزية والألمانية ولم تتح لهم هذه المعرفة رؤية الأمور من زوايا جديدة فحسب بل أتاحت لهم أيضاً بين أمور أخرى فرصاَ للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والدينية والمنظمات الأجنبية كعاملين وإداريين وإدلاء وسكرتارين ومترجمين
ثالثاً ازدادت الفرص أمام هذا الكادر المتعلم للعمل في خدمة الحكومة العثمانية وشكل مجموعة استخدمتها إدارة الانتداب البريطاني لاحقاً
رابعاً فتحت الأنظمة التعليمية الجديدة لهذه المجموعة الخاصة مجال الاستفادة من موارد خارج نطاق دعم البنية المحلية والعائلية تحديداَ الكنائس الراعية أو الجمعيات الخيرية مع فرص لاستكمال الدراسة.
ودخلت الأنشطة الرياضية المنظمة إلى حياة المقدسين الاجتماعية والتعليمية وحياة النخبة في ذلك الوقت وعلى الأرجح بتشجيع من مدارس الإرساليات التبشيرية الأوربية ويتذكر عزت طنوس الذي كان في الفترة 1905-1911، طالباَ في مدرسة سان جورج التابعة للكنسية الإنجيلية أنه لم يكن هناك مباريات في كرة القدم فحسب بل أيضا مباريات في أثناء فصل الصيف في الكريكيت وكرة السلة والهوكي وحظيت مباريات أيام السبت والمباريات السنوية بشعبية كبيرة وأصبح الجمهور العام متحمساَ للرياضة إلى درجة إن عدد المتفرجين على مباراة لكرة القدم في ملعب مدرسة سان جورج بلغ في سنة 1910، نحو خمسة ألاف متفرج بينهم بضع مئات من النسوة المحجبات وفي سنة 1912، كان لدى مدارس جمعية الكنيسة التبشيرية وسان جورج وجمعية الشبان المسيحية فرق لكرة القدم تبارت مع فريق الكلية البروتستانتية السورية الذي أتى من بيروت وفي العام التالي سافر فريق مكون من عدة مدارس من القدس إلى بيروت للعب ضد فريق الكلية المذكور
النشاط الاقتصادي في المدينة
على الرغم من التغيرات الكثيرة وازدياد عدد السكان منذ القرن التاسع فصاعداَ فإن النمو الاقتصادي والصناعي في فلسطين لم يتمركز في القدس بل إن مدن أخرى نمت بالمقدار نفسه إن لم يكن بمقدار أكبر ويشير روبرتس في كتابه الملامح المدينية للشرق الأوسط (Urban profile of Middle East) إلى أن في كثير من الحالات أرسى التطور الصناعي الأولي الأساس لنمو مستوطنات كانت تحت سيطرة عواصم سياسية في مكان آخر مثلاً يافا بدلاً من القدس نحو 35ألف نسمة وفي سنة 1915،أصبح أكثر من الضعف قليلا 80ألف بينما تضاعف عدد سكان يافا في الفترة نفسها أربع مرات من 10000إلى 40ألف وكذلك حيفا من 5000إلى 20ألف
إن الدراسات عن القدس في الفترة العثمانية تتحدث بالتفصيل عن حركة اقتصادية نشيطة لكن محدودة فالمواد الغذائية الضرورية لسكان القدس كانت تأتي من الأرياف المجاورة ومن مناطق أبعد وكانت فلسطين بصورة عامة كما القدس تستورد الأرز من مصر وإيطاليا وتستورد السكر من فرنساَ والبن من أمريكا الجنوبية وشبه الجزيرة العربية وكان البدو يؤمون المدينة للمتاجرة بالحبوب والمواشي وكان المزارعون يأتون من القرى المجاورة لتسويق الفاكهة والخضراوات والتجار يجوبون أنحاء المشرق للحصول على المنتوجات المحلية أو الإقليمية للمتاجرة بها وقد ذكر إدوارد روبنسون عالم آثار أمريكي عمل في فلسطين أنه كان في القدس في سنة 1838، تسعة معامل لصنع الصابون وعشر معاصر لزيت السمسم ومدبغة كبيرة وورشات كثيرة لصنع التحف التذكرية وفي أوائل القرن التاسع عشر كان هناك نحو عشر مصابغ للألبسة تبيع الأقمشة البيض والزرق للبدو والفلاحين وفي الخمسينيات كان هناك عشرون مطحنة للقمح في المدينة لكن مع تحولها إلى العمل بقوة البخار وازدياد إنتاجيتها أغلق كثير منها أبوابه وقبل الحرب العالمية الأولى كان هناك مصانع لصنع المعكرونة في يافا والقدس كما أن صناعة والحجر والطوب والسيراميك كانت جزءاَ من الأنشطة الاقتصادية في القدس قبل الحرب.
يؤكد بن أربيه أن إمكانات المدينة التجارية تحسنت باطراد مع تحول النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبحسب شولس فإن اقتصاد المدينة بقي اقتصاداً استهلاكيا تدعمه واردات من الخارج وتدعمه في حالتي الطائفتين المسيحية واليهودية أموال أجنبية وقد كتبت بيرتا سبافورد وهي من أوائل سكان الكولونبة الأمريكية التي أسست في سنة 1881، عن نحو 15ألفاَ إلى 20ألف حاج روسي زاروا القدس:
أوجدوا طلباً على جميع أنواع الحلي الصغيرة واستخدم عدد كثير من سكان القدس وبيت لحم للعمل في الورشات الكثيرة العاملة في صناعة التحف التذكارية بمختلف أنواعها وكان العاملون في صناعة الشمع يعملون على مدار السنة ليوفروا الكمية الكافية من الشموع لتلبية طلبات ألاف الحجاج الروس واليونان والأرمن والأقباط والمقدونيين الذين كانوا يأتون لحضور احتفال سبت النور الشتوي وبالإضافة إلى صناع الأيقونات والتحف الصغيرة المصنوعة من عرق اللؤلؤ وخشب الزيتون حصل صناع الأكفان على ربح وفير من رسم جماجم سود وعظمتين متصالبتين على قماش أبيض من الموسلين ليلبسه الحجاج الروس.....
وبالإضافة إلى ذلك أقيمت أسواق مرتبطة بعدة احتفالات بعيد "ستنا مريم" الذي كان يستمر أسبوعاَ كانت طائفة الروم الأرثوذكس تقيم مخيماَ على المنحدر الغربي لجبل الزيتون وتتذكر هالة السكاكيني التي حضرت الاحتفال في الثلاثينيات من القرن العشرين عندما كانت طفلة أن حشداَ من مختلف أنواع الباعة كان يتجمع في الموقع لتزدهر تجارة نشيطة وجلبت احتفالات النبي موسى التي تترافق مع عيد الفصح وتستمر أيضاًَ أسبوعاً الكثير من المسلمين الذين يتوافدون من جميع أنحاء فلسطين إلى القدس للمشاركة في الموكب المتجه إلى قبر النبي موسى في وادي الأردن ولم تكن هذه الاحتفالات مناسبة للباعة والتجار الموسمين فقط بل أيضاَ فرصة للقادمين من الأرياف لزيارة القدس وقد استمر كثير من هذه الاحتفالات حتى سنة 1948، عندما أدى تشريد السكان وتقسيم البلد إلى جعل السفر إلى الأماكن المقدسة أمراً مستحيلاً.
النمو السكاني أصبحت القدس في نهاية الحقبة العثمانية عشية الحرب العالمية الأولى أكبر مدينة في فلسطين والمركز السياسي والحضاري للبلد ويتضح من كثير من الدراسات المتعلقة بالموضوع صعوبة التواصل إلى تقديرات أكيدة لعدد السكان في تلك الفترة فالأرقام الواردة في الإحصاء العثماني لسنة 1905، تظهر أن مجموع عدد المواطنين العثمانيين في القدس في تلك السنة كان 32400 منهم 13400 يهودي و 11ألف مسلم و 8000 مسيحي لكن هذه الأرقام لا تشمل الأجانب الذين يعيشون في المدينة والذين من شأنهم على الأرجح زيادة عدد اليهود والمسيحيين وتورد المصادر اليهودية رقماَ لعدد السكان في السنة المذكورة أعلى كثيراَ بما فيها مصدر يقدر عدد اليهود بـ 50000نسمة من مجموع 75 ألف نسمة وتذكر المصادر العثمانية لسنة 1914، أن عدد المواطنين اليهود في قضاء القدس بأكمله كان 18190 يهودياَ أما المؤرخ يهوشواع بن أربيه الذي يفحص عدداَ لا حصر بشأن ديمواغرافية المدينة في ذلك الوقت فقد استنتج ما يلي:
في سنة 1917، رفع الكولونيل زكي بك رئيس نقابة القمح في القدس 31147 يهودياَ من مجموع السكان البالغ عددهم 53410 وقد استند هذان الرقمان إلى شهادات الميلاد وقيود الشرطة وأكد صحتهما أول إحصاء شامل أجراه البريطانيون في القدس في سنة 1922، وأظهر هذا الإحصاء أن إجمالي عدد السكان هو 62000منهم 34300 يهودي
لم يكن متبعاَ في تلك الفترة أن تشتمل الإحصاءات على تسجيل أماكن إقامة السكان بالمناطق المتعددة من المدينة لكن من المعروف إن مساحة المدينة الجديدة في بداية الانتداب البريطاني كانت أربعة أضعاف مساحة المدينة القديمة وكان عدد سكان المدينة الجديدة في نهاية الحكم العثماني بحسب تقديرات بن أربيه كما يلي 2000ـ2400 مسلم أي نحو 15%من العدد التقديري البالغ 12ألف مقدسي مسلم و 29 ألف يهودي من مجموع البالغ 45000يهودي في حين شكل المسيحيون 15%من سكان المدينة الجديدة أو تقريباَ 5000 إلى 6000 على أي حال استمرت المدينة في النمو كمنطقة سكنية للمسلمين والمسيحيين واليهود ويشير إحصاءات سنة 1922إلى 3،30% من المسلمين كانوا يعيشون خارج الأسوار.
البناء داخل أسوار المدينة وخارجها
منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى منتصفه تألفت القدس من المدينة المسورة ومن منشآت قليلة خارج الأسوار وداخل الأسوار كانت مدينة إسلامية في القرون الوسطى ومقسمة جزئياَ على الأقل تبعاَ للانتماءات الإثنية الدينية ويدل على ذلك أن التسميات و تقسيمات الأحياء الحالية الحي الإسلامي والمسيحي واليهودي والأرمني لم تكن موجودة وبالأحرى تكونت حارات على أساس سمات مشتركة قد تكون الدين أو الأصل أو القبيلة أو الانتماء الإثني أو الجماعة فأفراد عشيرة بني زيد الكائنة في الموقع المعروف اليوم باسم عقبة المولوية شرق باب العمود وكانت المناطق تسمى أيضاَ تبعاَ لمهنة أصحاب الدكاكين فيها كحارة الجوالدة دباغي الجلود أو بحسب معلم معروف كدير الروم أو خان الزيت نزل تجار زيت الزيتون.
وخارج الأسوار كان هناك مقابر وأبنية متنوعة ومنازل صيفية مسورة تعتبر جميعها جزءاَ من القدس لا من القرى المجاورة وكانت المقابر الإسلامية والمسيحية واليهودية تقع إلى شرق الشمال الغربي من الأسوار وكان خارج الأسوار أيضاَ عدد من المساجد والأربطة والزوايا والمدارس والخانات والمقامات قبور وأضرحة لكن مع حلول منتصف القرن التاسع عشر كان كثير منها قد فقد ازدهاره السابق ونذكر على سبيل المثال انه كان في القرن الثالث عشر خان وزاوية في موقع قبر الشيخ جراح أما المسجد الحالي القائم في الموقع فقد بني في سنة 1895-1896.
في منتصف القرن التاسع عشر اتخذ الاهتمام الأوروبي المتعاظم بالأرض المقدسة شكل نشاط عمراني متزايد من جانب الجماعات المسيحية وكان البروتستانت الإنكليز والألمان بحسب شولش أول أجانب شيدوا مباني جديدة داخل المدينة وخارجها أشهرها الكاتدرائية أي كنيسة المسيح التي دشنت في سنة 1849. ثم راح الروس وفرسان الهيكل الألمان والكاثوليك الألمان ولكاثوليك الإيطاليون جميعاَ يبنون الكنائس والنزل ومباني أخرى داخل الأسوار وخارجها وقد حققت هذه المشاريع الأوربية غرضها المنشود ففي سنة 1910، فاق عدد الحجاج الأوربيين السنوي للقدس عددهم قبل ذلك بأربعين عاماَ بما يتجاوز الضعف وقد أفاد هذا النشاط العمراني أيضاَ السكان المحليين وأحصى الرحالة فيتال كوينية في نهاية القرن التاسع عشر 17مستشفى و54مدرسة باستثناء مدارس المساجد الإسلامية في القدس وأنشئت خلال هذه الفترة مؤسسات تعليمية أوربية كثيرة للسكان القدس المحليين بينها مدارس مسيحية ويهودية بإدارة جماعات دينية إنكليزية وألمانية ونمساوية وفرنسية ويونانية قبل تلك الفترة وخلالها أقدم السكان المحليون أيضاَ على القيام بأعمال بناء مهمة وعلى الرغم من أنت جهودهم هذه ليست موثقة جيداَ فإننا مع ذلك نجد لها ذكراَ في مصادر مثل روايات الرحالة و الكتابات التاريخية والخرائط والسير الذاتية وقد تجاهل معظم كتابات الباحثين "الإسرائيليين" والصهيونيين مؤلفات الرحالة العرب إلى فلسطين والمؤرخين العرب بينما اعتمد بإفراط على أدب الرحالات الوصفي الذي ألفه حجاج أوربيون وثمة نمط من أنماط البناء خارج الأسوار تجاهلته أو قللت من أهميته الدراسات المتعلقة بالموضوع وهو المنازل الصيفية الكثيرة التي بنيت في شمالي شرقي وجنوبي غربي المدينة المحاطة بالأسوار وكان بعض هذه المنازل قصوراً بناها الأغنياء وأصحاب النفوذ وكانت محاطة بالأراضي المزروعة وأشجار الفاكهة وغالباً ما وجد فيها مطاحن أو معاصر للزيتون وتتحدث روايات الرحلة العرب عن هذه المنازل الكبيرة في منطقتي البقعة وجبل الزيتون في العصرين المملوكي والعثماني.
من منتصف القرن التاسع عشر والنصف الثاني منه أصبح من المعتاد أن يمضي المقتدرون الصيف خارج الأسوار هرباَ من حر القدس الشديد في الصيف ومن الأحوال الخانقة في المدينة القديمة المزدحمة وكان القرويون والمزارعون ينتقلون دائماً مع عائلاتهم للإقامة في مواسم الزرع والحصاد بالبيوت الصغيرة التي شيدوها قرب حقولهم واستمرت عائلات النخبة في ممارسة التقليد المتبع في القرون السابقة بالسكن في قصور وبناء منازل أخرى صيفية خارج الأسوار وكان بيت المفتي المنزل الصيفي الخاص بعائلة الحسيني وقد شيد في ستينيات القرن التاسع عشر وأعيد بنائه بفخامة بين سنتي 1890 و1895، وخلال هذه الفترة تخطت عادة بناء منازل صيفية النخبة والفلاحين لتنتشر بين عائلات الطبقة الوسطى وخصوصاَ العائلات المسيحية ففي الثمانيات بنيت عائلة السكاكيني التي كانت تقطن في الحي المسيحي في البلدة القديمة منزلاَ صيفياَ في المصرارة كما كان جيرانها عائلة عبدو يمضون الصيف خارج الأسوار يقع في ماميلا وتملكه بطريركية الروم الأرثوذكس في مبنى يدعى الحريرية وفي التسعينيات انتقل نيقولاس سبيريدون وهو طبيب يوناني مع عائلته من منزل في البلدة القديمة تملكه البطريركية ذاتها وفي سنة 1897، اشتري هذا الطبيب 21 قطعة أرض من فلاحي المالحة وبنى منزلاً ريفياًَ أوصيفياَ وزرع أشجار زيتون وكينا وحفر بئراَ أيضاَ وقد نمت الأحياء والضواحي أو التجمعات السكنية نحو المدينة الجديدة
كان القلق الشديد إزاء الأمن السبب الرئيسي الذي يعزى إليه البطء النسبي في توسيع المدينة خارج الأسوار في البداية فحتى السبعينيات من القرن التاسع عشر كانت بوابات المدينة تغلق ليلاَ وفي أثناء صلاة الجمعة عند المسلمين لكن لا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضاَ أن أسوار مدينة القدس كان يمكن أن تحيط بالسكان بسهولة لقلة عددهم وبالتالي كان الحافز على ترك المدينة ضئيلاَ وكانت مسألة الأمن مرتبطة بعلاقات معقدة بين الوجود العثماني العسكري والزعماء المحليين وقطاع الطرق الذين كانوا يهاجمون الأشخاص غير المحميين ويسلبونهم وعندما أصبحت القدس متصرفية في سنة 1858، ازداد الحضور العثماني الإداري والعسكري الأمر الذي جعل المدينة تبدو أكثر أمناَ ومحمية على نحو أفضل لكن الحقيقة أن العائلات القاطنة في حي النبي داود المجاورة لأسوار المدينة القديمة وفي القرى القريبة الطور سلوان العيزرية دير أبو ثور وغيرها كانت تعيش قبل ذلك من دون أسوار وبالتالي كان يمكن للعيش خارج الأسوار أن يكون آمنا من الهجمات والغارات إلا أن هذا ربما لم يكن ممكنا بالنسبة إلى المهاجرين اليهود الذين لا يجيدون اللغة العربية وليس لهم علاقات بالشيوخ والزعمات المحليين والروايات الصهيوينة و"الإسرائيلية" التي تشدد على زيادة الأمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر باعتبار السبب الرئيسي في النمو خارج الأسوار تكشف عن منظور أحادي الجانب إلى علاقات تلك الفترة وأحداثها مع ازدياد النمو في عدد السكان وتنامي الهجرة اليهودية ازدادت العوامل التي تدفع السكان إلى البناء خارج المدينة القديمة المسورة وكان من الدوافع الرئيسية إلى ترك المدينة الازدحام الشديد ومشكلات الصحة العامة فالحصول على المياه في البلدة القديمة مشكلة ولا سيما خلال أشهر الصيف الحارة بينما كان في وسع القاطنين خارج الأسوار أن يحفروا آبار أسفل منازلهم لتخزين مياه الأمطار المنسابة من على سطوح المنازل خلال فصل الشتاء فيخففوا بذلك من اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على المياه أو إلى تقنين استخدامها في الصيف إن الأغلبية العظمى من الدراسات المتعلقة بنمو المدينة الجديدة تركز على ظهور الأحياء من قبل جمعيات بناء يهودية أو مشاريع خيرية حافظت على قواعد وأنظمة وسجلات مفصلة تجعل هذا الجانب الخاص من نمو البناء في المدينة الجديدة يفهم كسعي منظم بصورة معقولة لكن النموذج النظري القائم على التشديد على الأحياء ينطوي على إشكاليات الأخرى في بناء المنازل وتكون التجمعات السكنية على أنها شذوذ عن القاعدة وهكذا لم تجد طريقها إلى كتب التاريخ إلا الأحياء المخطط لها فقط
إن التوثيق الدقيق لمشاريع البناء العربية في الفترة الأولى والشبيه بالتوثيق التعلق بمشاريع البناء اليهودية شبه غائب فمشاريع البناء العربية كانت تجري بصورة مختلفة إذ كانت تتم إما بمبادرات فردية أو عائلية وإما بمبادرات من أوقاف مسيحية وكان التوسع العربي خارج الأسوار في الأساس مشروعا خاصاَ قائماَ على توفير الأرض ورأس المال العائلي ويفتقر إلى الإجراءات الرسمية والتنظيمية المتبعة في إنشاء الأحياء اليهودية وقد عمد بعض العائلات المسلمة التي اشترت أرضاَ وسكنت خارج الأسوار إلى تحويل أملاكها إلى أوقاف لإبقاء ملكية الأرض داخل العائلة ولم تنشر بشأن هذا الموضع سوى أبحاث قليلة وبالتالي فإن محفوظات العائلات وسجلات المحكمة الشرعية الإسلامية ووثائق الأوقاف المسيحية يمكن أن تكشف أكثر عن الممارسات التي تخص تحديد ملكية البناء والأرضي بالنسبة إلى المقدسين العرب والأرمن واليونان كما تزودنا المذكرات واليوميات والروايات الشفهية فهماَ أعمق لعملية البناء والحصول على الأراضي خارج الأسوار.
ثمة دليل آخر يتعلق بتاريخ البناء في القدس ينطوي هو أيضاَ على إشكالية فخرائط كثيرة عائدة إلى تلك الفترة وضعها أجانب ولهذا يظهر أثر الأنشطة الدينية والتبشيرية بصورة بارزة فيها إن صفقات شراء الأراضي والمباني اليهودية وسجلات الحكومة العثمانية وكانت تحفظ في ذاكرة كل طائفة وسجلاتها كمحطات مهمة في مسيرة توسعها في الأرض المقدسة ولذا فإن هذه المصادر تميل إلى تجاهل البناء المحلي وسيتناول الفصل التالي الصعوبات الكامنة في المادة التاريخية التي يستخدمها الباحثون في تفسير توسيع المدينة الجديدة وفي التوثيق المتعلق ببدايات البناء الممول محلياَ.
تتفق تواريخ القدس على أن أول حي بني خارج أسوار المدينة القديمة كان مشكنوت شأنانيم وهو مشروع بناء يهودي قام به موزس مونتفيري وكان عبارة عن عشرين منزلاً بدأ بناؤها في سنة 1855،وأنجز في سنة 1860، كما بني في الفترة نفسها عدد من المنازل الخاصة والمشاريع التبشيرية بما فيها المسكوبية أنجز بناؤها في سنة 1860، ومدرسة المطران غوبات على جبل النبي داود وميتم شنلر والبيت الصيفي للقنصل البريطاني فن في الطالبية وتظهر في خريطة ويلسون لسنة 1864، مستوطنة يهودية في الطالبية ودكاكين خارج باب الخليل ومقهى أرمني ومبنى حراسة تركي.
إذا نظرنا إلى الموضوع من منظور الوصف المدون للمدينة والسجلات التاريخية حولها والتي غالباً ما يجري ذكرها في المؤلفات الأكاديمية والروايات الأكثر شعبية لتاريخ المدينة يبدو كأن سكان المدينة العرب واليونان والأرمن لم يفكروا في العيش خارج الأسوار في تلك الفترة وإذا كان صحيحاً أنه لم يكن هناك مشاريع بناء عربية و يونانية وأرمينية منظمة خلال فترة التوسع الأولية فإن من شأن التركيز على الحالات الموثقة جيداَ فقط إهمال جانب مهم من نمو المدينة فجهود العرب وغيرهم لبناء منازل لإقامة دائمة على مدار العام على أرض خاصة غير موثقة إجمالاً أو على الأقل لم تجر دراستها بصورة جدية كما أن الحديث عن التوسع خارج الأسوار لا يعتبر المنازل الصيفية العربية جزءاَ من الأماكن السكنية وبالإضافة إلى ذلك فإن من الضروري دراسة العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية وقيامها بتأجير الأراضي ليس بالضرورة في مقابل مال لأتباعها كي يبنوا خارج الأسوار فهناك مبان يشار إليها في الخرائط والسجلات على أنها من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في أنها قد تكون مباني سكنية لعرب ويونان من أتباع الكنيسة.
مجلة صندوق استكشف فلسطين الفصلية (Palestine Exploration Fund Quarterly)
ذكر أنه في سنة 1881، كان هناك بين القاطنين خارج الأسوار والبالغ عددهم 2500نسمة 1510من اليهود وهناك رسالة كتبها أحد سكان الكولوينة الأمريكية في سنة 1883، تلقي الضوء على أنشطة البناء في تلك الفترة:
إن أنشطة إعادة البناء لا تقتصر بالتأكيد على اليهود فالكاثوليك واليونان والمسلمون والبرتستانت جميعهم يشاركون فيها وحالياَ هناك أكثر من مئة بناية قيد الإنشاء جميعها من الحجر ومعظمها من الحجر المشذب بعناية والطريقة الجديدة هي استخدام عوارض حديد لدعم السقف ومن ثم تغطى هذه بقرميد فرنسي بدلاَ ً من السقف المقبب الأقدام طرازاَ والأجمل منظراَ.
وبالإضافة إلى ذلك فإن أساليب البناء التي اتبعها سكان المدينة العرب المسلمون منهم والمسيحيون غير قابلة بسهولة للتصنيف كـأحياء خلافاَ المساكن اليهودية المبكرة وفي بعض الحالات كانت العائلة الصغيرة أو الممتدة تشتري الأرض وتبدأ البناء مجتمعة في منطقة فسيحة تتسع للأجيال المقبلة كي تواصل إضافة بيوت في المنطقة قالنمرية والوعرية كانتا مساحتين في منطقة البقعة في المدينة الجديدة اكتسبتا تسميتها من أفراد من عائلتي النمراوي والوعري انتقلوا إلى خارج المدينة القديمة وأسسوا أوقافاَ عائلية خلال العهد العثماني وفي حالات أخرى كانت العائلة العربية تبني منزلاًَ مصمماً بصورة مستقلة عن قطعة من الأرض تملكها وهي عادة تشيد عليها تواريخ العائلات ويمكن ملاحظتها بسهولة في طراز الأبنية في الحيين العربيين الطالبية والقطمون اللذين نشآ لاحقاَ ومن جهة أخرى بقيت أملاك الكنسية مسجلة باسمها لكنها أجرت أو منح حق الانتفاع بها في مقابل مبالغ من المال أو خدمات الأمر الذي وفر لعدد من المسحيين بيوتاَ خارج أسوار المدينة القديمة وبالإضافة إلى الأساليب المتعددة في البناء كان هناك اختلافات كبيرة في طابعه والأموال المستثمرة فيه يصف دافيد يلين وضع البناء في سنة 1900، كما يلي:
يبلغ مجموع عدد الملاك الجدد 111شخصاَ من هؤلاء 56يهودياَ و 27مسلماَ ويجب أن يضيف المرء أيضاَ البلدية التي شيدت مبنى من الرسوم التي حصلتها من جميع سكان المدينة.
إن الرقم الدقيق ليس ضخماَ على الإطلاق وهو يعكس في الحقيقة حالة الركود في مجال البناء في القدس في هذه الفترة وعندما نرى أن 54 من غير اليهود شيدوا منازل في القدس في هذه السنة نعرف أن 54 بناية كبيرة أضيفت بينما بني عدد قليل من الـ 56 يهودياَ منازل جديدة فهؤلاء ببساطة ملاك سابقون في معظمهم أضاف كل منهم إضافة صغيرة إلى منزله القديم ..
إن قيمة المنازل الـ27المسيحية هي على الأقل 756500 قرش وقيمة المنازل اليهودية 000،263قرش وقيمة المنازل الـ27 الإسلامية 242000 قرش وقيمة مبنى البلدية 9000
إن قيمة كل منزل من المنازل الإسلامية تساوي في المتوسط مرة ونصف قيمة كل منزل يهودي وقيمة كل منزل مسيحي تساوي الضعف..
ونسبة الأغنياء بين المسحيين من أصحاب هذه المنازل هي54% وبين المسلمين 33% أما بين اليهود فهي 12% فقط وبالإضافة إلى ذلك تبلغ قيمة أغلى المنازل اليهودية 20000، بينما تبلغ قيمة أغلى المنازل الإسلامية والمسيحية أعلى من ذلك كثيراَ
إن أساليب البناء والميل إلى الاستثمار فيه هي مما يميز البناء العربي خلال الحقبة العثمانية وفترة الانتداب البريطاني وفي نظر المقدسين العرب تحولت المدينة الجديدة من مكان يرمز إلى الابتعاد عن الروابط العائلية والعزلة إلى مكان يتمتع بمحيط صحي وأمان نسبي كما أصبحت مكاناً يمكن أن تعبر فيه الطبقتان العليا والوسطى عن قيمة ثرائهما من خلال التصاميم المعمارية والحدائق الغناء على نحو لم تكوناَ قادرتين على فعله في البلدة القديمة المزدحمة مع ذلك لم تكن المدينة الجديدة للعائلات الثرية جداَ فحسب إذ تكشف تواريخ العائلات أن الأغنياء العرب بدؤوا بناء منازل ومبان تجارية وتأجيرها وهكذا صار متاحاَ لكثيرين من العرب واليهود أن يتركوا المدينة القديمة ويستأجروا في المناطق الجديدة حتى لو لم يكن لديهم رأس المال المطلوب لشراء قطعة أرض وبناء منزل عليها وأتاحت الأملاك الواسعة للكنسية الأورثوذكسية والكنيسة الأرمنية فرصاَ مشابهة لأتباعهما.
وتقدم الأمثلة نماذج من التفاوت في المعلومات المتوفرة عن توسع البناء ففي سبعينيات من القرن التاسع عشر أسس اتحاد كنيست يسرائيل جمعية إيفن يسرائيل واشترى قطعة أرض من أجل بناء 53 منزلاَ ونجد في سجل أنظمة الجمعية تفصيلات القرعة التي أجريت لتوزيع المنازل وأسماء مؤسسي الأحياء وتكلفة الأرض وطريقة الشراء أما البحث عن معلومات بشأن التوسع السكني للعرب اليونان والأرمن خارج المدينة القديمة فإنه في المقابل ضعيف النتائج وقد سجل في تاريخ أحدى العائلات أن زوجين أرمنيين متزوجين حديثاَ في سنة 1858، سكنا خارج المدينة في حي ماميلا في منزل ورثه العريس عن والده وبعد وفاة الزوجة في سنة 1884، قدم الزوج التماساَ للبطريرك الأرمني لمنحه غرفة في الحي الأرمني كتب فيه من المستحيل أن أعيش خارج البلدة القديمة وأترك أولادي بين الأتراك والجنود والناس الأغراب الآخرين ومن المشكوك فيه أن يكون الزوجان الشابان غامرا بالعيش خارج الأسوار وحدهما ولأرجح وجود عدد من المنازل الأخرى في المنطقة إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود مبان سكنية على خريطة تعود إلى تلك الفترة كما روت بيرتا سبافورد فيستر حادثة جرت في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانيات من القرن التاسع عشر هي أن شاباَ من عائلة كاثوليكية من حارة السعدية داخل باب الساهرة كان يبني لنفسه منزلاً في نهاية شارع يافا قبالة القنصلية البريطانية لكنه توفي قبل أن يعقد قرانه وبقي المنزل غير مكتمل وتذكر فيستر هذه الحادثة لأن المنزل بقي خالياً عدة أعوام وإن والدتها روت لها القصة وقد سجلت تاريخ المنزل في مذكراتها بسبب الحادثة المأسوية المرتبطة به لكن الاعتماد على مثل هذه المصادر يكشف عن الوضع الصعب لدى استقراء السجل التاريخي المدون كم من المنازل بناه المقدسيون ولم يجر قط توثيقها أو تدوينها؟ إن الأوراق العائلية وسجلات البلدية ووثائق الأوقاف الإسلامية والمسيحية هي المفتاح للكشف عن تاريخ البناء العربي في المدينة الجديدة.
نهاية الحكم العثماني للقدس
ألحقت الحرب العالمية الأولى أذىً كبيراَ بسكان القدس شأنهم شأن السكان في أنحاء المشرق كافة وأدى ما أصاب البلد من تجنيد إجباري ومجاعات وأمرض ونقص في الإمدادات إلى ركود مجرى الحياة الطبيعية في القدس كما أن عدم وضوح الرؤية المستقبلية ومشاعر الاستياء من السلطة العثمانية والتي بدأت تتنامى منذ أوائل القرن العشرين والمزاج العام للسكان والحالة الاقتصادية في الإمبراطورية أدت كلها إلى إعاقة النمو والاستثمار في البناء والتوسع اللذان كانا من سمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهكذا وفي ضوء المقابلة بهذا الوضع نظر إلى الاحتلال البريطاني للمدينة في سنة 1917، باعتباره قد وفر الاستقرار والخدمات للسكان وولد الوضع الجديد لدى الناس ثقة بالمستقبل نجمت عنها فترة ثانية من النمو في بناء المنازل وفي الأعمال خارج الأسوار.
لقد نمت أسس التجمعات السكنية في المدينة الجديدة الكولونية الألمانية الكولونية اليونانية والقطمون والطالبية والبقعة وغيرها في الفترة العثمانية المتأخرة بسبب التغيرات في الإدارة وفي القوانين العثمانية المتعلقة بالأراضي ووفرازدياد الوجود العثماني والشعور بالأمان إضافة إلى النمو الاقتصادي للمدينة عوامل دافعة شجعت سكان القدس على الشروع في البناء خارج المدينة المسورة كما أن الازدحام الشديد داخل الأسوار والرغبة في إظهار الثروة والمكانة في الزخارف المعمارية دفعا بالعائلات الإسلامية والمسيحية الثرية إلى المدينة الجديدة ووفرت الكنائس المسيحية ولا سيما الكنيستان الأرثوذكسية اليونانية والأرمنية الفرص لرجال الدين وغيرهم من أتباعها للعيش في أملاك الكنيسة خارج الأسوار وساهمت في ذلك بوجود مسيحي كبير في أجزاء من المدينة كان النسيج الاجتماعي للقدس يتغير هو أيضاَ فالمدارس التي أنشأتها الإرساليات المسيحية والسلطات العثمانية والمربون العرب المحليون وفرت فرصاَ مهمة للناس لتغير حياتهم بالتعليم واكتساب مهارات أهلتهم لطرق عيش مختلفة ومنحتهم فرصاَ اقتصادية كالوظائف الإدارية والاحتكاك المتزايد بالسياج وفي حين توقف الكثير من هذه التحولات خلال سنوات الحرب العالمية الأولى فقد عادت بقوة في ظل فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
المراجع العربية
أمين أبو بكر ملكية الأراضي في متصرفية القدس 1858-1918- عمان مؤسسة عبد الحميد شومان 1996.
أسامة حلبي بلدية "القدس العربية" القدس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية 1993.
يوسف خوري الصحافة العربية في فلسطين 1876-194بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1976،
مصطفى الدباغ بلادنا فلسطين المجلد 8 الجزء الثاني كفر قرع دار الشفق1988،الطبعة الثانية
خليل السكاكيني كذا أنا يا دنيا أعدتها للنشر هالة السكاكيني القدس المطبعة التجارية 1955،
عارف العارف المفصل في تاريخ القدس القدس مكتبة الأندلس 1992الطبعة الثالثة كامل موسم النبي موسى في فلسطين تاريخ الموسم والمقام عمان الجامعة العودات يعقوب من أعلام الفكر والأدب في فلسطين القدس دار الإسراء 1992، الطبعة الثانية
شمعون لاندمان أحياء أعيان القدس خارج أسوارهافي القرن التاسع عشر تل أبيب دار النشر العربي 1984،مترجم عن العبرية
عبد الرحمن ياغي حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة بيروت المكتب التجاري 1968.